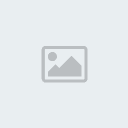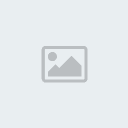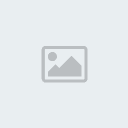لا يوجد في سورية حلّ على الطريقة
المصرية والتونسية ولا الليبية أو اليمنية، لاختلاف طبيعة السلطة وتركيبة
المجتمع وحجم المداخلات الخارجية،
وأيضاً، لأن السلطة في سورية انتهجت
الحل العسكري منذ البداية، على قاعدة «الأسد أو نحرق البلد»، أي أنها باتت
بمثابة سلطة احتلال، بدليل إمعانها في التدمير والتقتيل في سورية
والسوريين.
على ذلك فإن مجمل
«المبادرات» السياسية التي طرحها هذا النظام كانت مجرد خدعة كبيرة، لأن
البلد عنده بمثابة «عزبة» خاصة يتم توارثها من الآباء إلى الأبناء، في
مطابقة للشعار المشين: «سوريا الأسد إلى الأبد».
هذا يفسّر استعداد النظام للمساومة على
كل شيء، عدا احتكاره للسلطة، فهو مستعد للمساومة على رئاسة الحكومة
وتشكيلتها وعلى انتخابات مجلس الشعب وحرية الإعلام، وغير ذلك، وهذا معنى
الحوار تحت «سقف الوطن» أو تحت «سقف الأسد» بتعبير أدق!.
والحال فإن النظام في سورية، منذ
42 عاماً، هو مجرد طغمة حاكمة أو عصابة (بحسب تعبير معاذ الخطيب رئيس
الائتلاف الوطني السوري)، فلا الحكومة تحكم ولا مجلس الشعب يشرّع،
وهي طغمة
تغولت على الدولة والمجتمع، وهي التي ينبغي التخلص منها إلى الأبد، مع
أجهزتها الأمنية، لعبور مجال التغيير السياسي في هذا البلد.
حقاً، لقد انتهى نظام الأسد، ليس من اليوم، ولا مع تحول الثورة إلى التغيير بالسلاح، وإنما منذ اندلاع الثورة،
مع تشليع أظافر أطفال درعا،
ومنذ إطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين في درعا ودوما وبرزة والميدان، قبل قرابة عامين.
مع ذلك فإن أي حرب هي امتداد للسياسة،
والثورة كأي ثورة قد تضطر، في إطار صراعها، من أجل تغيير الواقع القائم،
إلى خوض تسويات معينة، في سبيل تقليل الأكلاف والمخاطر، لا سيما إذا كانت
قواها ليست على الدرجة التي تمكّنها من تحقيق الغلبة بأكلاف معقولة
ومحمولة.
مجدّداً، لا أقل من إسقاط النظام، الذي
لا شرعية له، لكن مشكلة الثورة السورية أنها لم تستطع إنجاز ذلك بعد 22
شهراً على اندلاعها، و 60 ألف شهيد، وأضعافهم من الجرحى، وثلاثة ملايين
لاجئ ونازح، وكل هذا الخراب في البيوت والممتلكات والعمران، على رغم تصميم
السوريين وتضحياتهم ومعاناتهم وشجاعتهم المدهشة، التي جعلت من ثورتهم
الأبهظ كلفة بين مجمل ثورات الربيع العربي، وغير العربي.
ثمة مشكلات وتعقيدات كبيرة لهذه الثورة، وكلما استمرت كلما ازدادت، وهذا طبيعي، ويمكن تفهمه،
وخصوصاً لكون سورية بلداً مفتاحياً، يؤثر في جوارها، وما بعد جوارها.
وهنا إسرائيل أيضاً، التي يحرص الغرب على ضمان أمنها.
في الداخل ثمة واقع اجتماعي جد صعب، ومعقد،
فثمة جماعات سورية لم تنخرط تماماً في
الثورة، ليس حباً بالنظام، وإنما لعدم يقينها من المستقبل، وهو واقع
ينبغي إدراكه بطريقة صحيحة والتعامل مع متطلباته.
أيضاً، ثمة إجهاد واستنزاف لمجتمع
الثورة، ذلك أن المناطق الحاضنة تعرضت لتدمير منهجي، ووحشي، ما يصعّب على
الثورة، ويزيد أعباءها، لا سيما مع تفتّت البيئات المجتمعية المساندة،
وتشرد أبنائها، وافتقادهم لقمة العيش.
هذا ليس بالشيء الهيّن، لأنه ينعكس على فعاليات الثورة، بتآكل طابعها المدني/الشعبي،
وهذه ليست حالة صحية، فضعف مجتمع الثورة يضعف الثورة ذاتها، حتى لو امتلكت أسلحة،
ما ينبغي ملاحظته،
لا سيما أن من مهمات القيادة التقليل من المخاطر وإدارة الموارد بأفضل ما
يمكن، والوصول إلى الهدف بأقل أكلاف ممكنة.
أما بالنسبة إلى الوضع الدولي، فمن الواضح أن الثورة بحاجة ماسة لمساعدات خارجية، للتسهيلات اللوجستية، وللسلاح، والدعم المالي،
لكن الدول لا تشتغل كجمعيات خيرية ولا بعقلية مبدئية أو أيديولوجية، ولا بالعواطف،
وإنما تشتغل بعقليات براغماتية وسياسية ومصلحية،
وبديهي أن أي دعم يقدم للثورة إنما
يبتغي إخضاعها إلى ارتهانات وتوظيفات وتوجيهات معينة، ما يفرض على الثورة
تنظيم تصريفها لطاقتها، وتعزيز الاعتماد على مواردها، والموازنة بين
حاجاتها ومبادئها، وبين إمكانياتها وأشكال عملها.
لكن ذلك لا يفترض التراجع عن المضي
بهدف إسقاط النظام، الذي هو «الصحّ الوحيد» في حياة السوريين، على ما يقول
ياسين الحاج صالح محقّاً،
وإنما يعني التعامل مع هذا الوضع المعقد بعقلية سياسية، لا بعقلية أيديولوجية تطهرية وشعاراتية،
فالصراع لا بد أن يفضي إلى حلول سياسية،
وبقدر ما أن مهمة القيادة المسؤولة
التأكد بأن لا تعيق هذه الحلول إنجاز الهدف المتوخّى، بل أن تشكّل طريقاً
محتوماً إليه، فإن مهمتها أن لا تجد نفسها فجأة في واقع يفرض عليها القبول
بأي شيء.
الحقيقة أن هذا الوضع كانت رصدته بصورة
أعمق مواد سابقة نشرتها هذه الصحيفة، لا سيما للزملاء ياسين الحاج صالح
(9/12) وجاد الكريم الجباعي (31/12) وعصام الخفاجي (1/1) وعبد الوهاب
بدرخان (3/1) وراغدة درغام (4/1).
هذا يفيد بأن الثورة السورية أحوج
ما تكون إلى طرح مبادرة سياسية، أو «خريطة طريق» للمرحلة الانتقالية،
لتوضيح ذاتها إزاء الأطراف المكونة لها، وإزاء مجتمعها، بمختلف أطيافه
وتلاوينه، وإزاء العالم، الذي تنشد دعمه،
هذا من دون صلة بخطة الإبراهيمي أو غيرها،
هذا له علاقة بالثورة ومصالحها وطريقة إدارتها لأحوالها.
الآن، ثمة في مجال التداول في شأن سورية مشروعان،
أولهما يتأسس على تسوية مع بقاء النظام،
وثانيهما يتأسس على تسوية من دون النظام.
المشروع الأول، تطرحه كل من إيران وروسيا، وهو مناسب للنظام،
لأنه يطيل عمره، لكن مشكلته أن الزمن تجاوزه، بالنسبة إلى غالبية
السوريين، أي حتى للجماعات الصامتة والمترددة، كما بالنسبة إلى القوى
الإقليمية والدولية الفاعلة في الوضع السوري.
أما المشروع الثاني، الذي يقوم على مرحلة انتقالية من دون الأسد وطغمته الحاكمة، فتقف
وراءه قوى دولية وإقليمية، وهي تنضجه على مهل، في مراهنة على وهن النظام،
وإمكان تراجع روسيا عن عنادها في شأن إبقاء موطن قدم للأسد في هذه
التسوية.
هذا مشروع موجود، وتحدث عنه الإبراهيمي
بعبارات ديبلوماسية غامضة ضمنها قوله أن «السوريين يفضلون نظاماً
برلمانياً على نظام رئاسي»،
وأكد عليه وزراء خارجية كل من فرنسا ومصر،
والناطقة بلسان الخارجية الأميركية، الذين تكلموا صراحة، في الأيام الماضية،
عن أن لا مكان للأسد في المرحلة الانتقالية،
وأن على الأسد أن يتنحّى.
هذا مشروع ربما يشكّل فرصة مواتية للثورة السورية للبناء عليه، وتكريس فكرة إسقاط النظام، مع أدواته الأمنية.
أما نهج الرفض
المسبق والمطلق لأي حل، حتى ولو كان يتقاطع مع إسقاط النظام، لصالح
التشبّث بالحل العسكري وحده، فهذا قد يضعف الثورة، ويتركها لمصيرها، ويزيد
أكلافها، ويصعّب من طريقها، لا سيما بعد أن باتت ثورة مسلحة وتحتاج إلى
الكثير، القليل منه لا يتوفّر.
القصد أن الثورة السورية معنية بأخذ زمام المبادرة، بطرح «خطة الطريق» خاصتها للمرحلة الانتقالية، وملاقاة أي تصور سياسي يتأسّس على الانتهاء من النظام،
وربما أن هذه الثورة معنية، فوق ذلك، بالمبادرة إلى تشكيل حكومة انتقالية موقتة، تكون أكثر تمثيلاً لمجمل مكونات الشعب السوري.
الخطة والحكومة باتتا بمثابة ضرورة
لترشيد إدارة الثورة لأحوالها ولمجتمعها، بعد عامين تقريباً على انطلاقها،
ومع وجود مناطق محررة واسعة، تحتاج إلى مجالس محلية،
فالدول تدار بالحكومات وليس بالائتلافات السياسية،
والحكومات تعترف بحكومات لا بجماعات سياسية أو عسكرية.
لم يعد يكفي الثورة، وائتلافها الوطني، التوافق على وثائق في هذا الاجتماع أو ذاك،
فقد تزعزعت هذه الإجماعات في بيان لجماعات مسلحة في حلب دعت إلى دولة دينية،
وفي هيمنة لون سياسي على «المجلس الوطني» وبعده على الائتلاف.
هذه أمور مضرّة بالثورة وبمسارها وبالإجماعات من حولها، ما يستدعي الانتقال إلى حالة حكومة وطنية انتقالية.
هذا يسهل إدارة الثورة لأوضاعها ويسهّل على الآخرين التعامل معها،
بعيداً عن العقليات الضيقة والحزبية، والتي لا تأخذ طابع سورية، وواقع التنوع والتعددية فيها.
فضلاً عن ذلك فإن السوريين معنيون بتوضيح الطابع الديموقراطي والمدني لثورتهم، لا تصدير جماعة مثل «جبهة النصرة».
والأهم أن الشعب السوري بمختلف أطيافه بحاجة إلى ذلك، أي إلى نوع من يقين بشأن المستقبل،
هذا ينطبق على «طائفة» الصامتين و «طائفة» المترددين و «طائفة» الخائفين.
هؤلاء ينبغي أن تستقطبهم سورية المستقبل، وأن تتشكّل التسوية معهم في عقد اجتماعي جديد.
طبعاً ثمة من يعتقد عدم جواز عقد أي
تسوية، وأنه ينبغي المضي بالثورة المسلحة إلى نهاياتها، لكنس نظام الأسد
نهائياً، ومحاكمته هو وأتباعه، أو قتله كما القذافي، لكن هذا يتطلب شروطاً
كثيرة، أغلبها غير متوافر، فضلاً عن أن تأمين هذه الشروط والمستلزمات (لا
سيما ما تعلق بالسلاح والمال وحرية الحركة) يفرض شروطاً على الثورة
ذاتها، ضمنها الارتهان لدول إقليمية وغربية.
عموماً، في السياسة والصراعات السياسية لا يجوز القول برفض الحلول السياسية بشكل مطلق ومسبق،
كما لا ينبغي إعطاء هذا النظام الخسيس فرصة لمزيد من التقتيل والتدمير بحق سورية والسوريين،
فشعار العار: «سورية الأسد إلى الأبد»، انتهى إلى غير رجعة،
وهذا النظام ساقط.